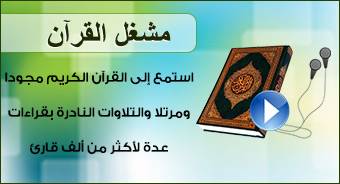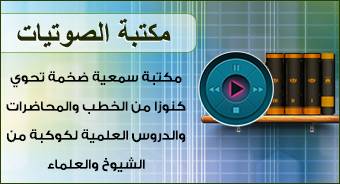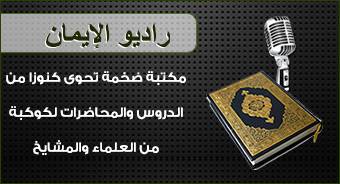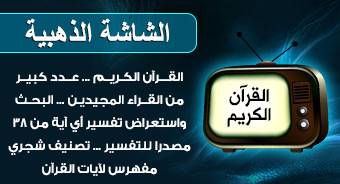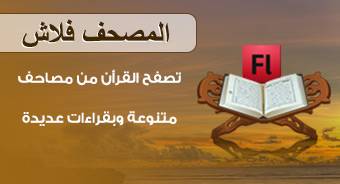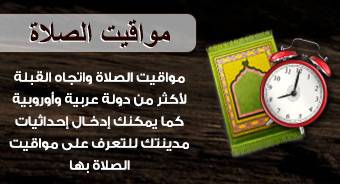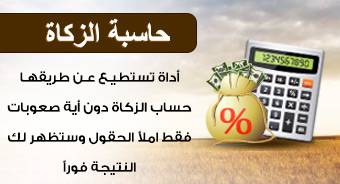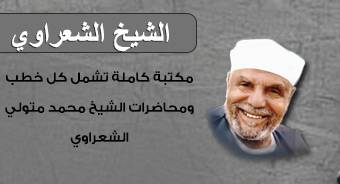.[الجن: الآيات 16- 17]
.[الجن: الآيات 16- 17]
{وأنْ لوِ اسْتقامُوا على الطّرِيقةِ لأسْقيْناهُمْ ماء غدقا (16) لِنفْتِنهُمْ فِيهِ ومنْ يُعْرِضْ عنْ ذِكْرِ ربِّهِ يسْلُكْهُ عذابا صعدا (17)}.
{وأنْ لوِ اسْتقامُوا} أن مخففة من الثقيلة، وهو من جملة الموحى. والمعنى: وأوحي إليّ أن الشأن والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلى، أى: لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة اللّه والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام، لأنعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم. وذكر الماء الغدق وهو الكثير بفتح الدال وكسرها.وقرئ بهما، لأنه أصل المعاش وسعة الرزق
{لِنفْتِنهُمْ فِيهِ} لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا منه. ويجوز أن يكون معناه: وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاسماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم، لنفتنهم فيه: لتكون النعمة سببا في اتباعهم شهواتهم، ووقوعهم في الفتنة، وازديادهم إثما، أو لنعذبهم في كفران النعمة
{عنْ ذِكْرِ ربِّهِ} عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه
{يسْلُكْهُ} وقرئ بالنون مضمومة ومفتوحة، أى: ندخله عذابا والأصل: نسلكه في عذاب، كقوله:
{ما سلككُمْ فِي سقر} فعدّى إلى مفعولين: إمّا بحذف الجار وإيصال الفعل، كقوله:
{واخْتار مُوسى قوْمهُ} وإمّا بتضمينه معنى (ندخله) يقال: سلكه وأسلكه. قال:
حتّى إذا أسلكوهم في قتائدةوالصعد: مصدر صعد، يقال: صعد صعدا وصعودا، فوصف به العذاب، لأنه يتصعد المعذب أى يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. ومنه قول عمر رضى اللّه عنه: ما تصعدنى شيء ما تصعدتنى خطبة النكاح، يريد: ما شق علىّ ولا غلبني.
 .[الجن: آية 18]
.[الجن: آية 18]
{وأنّ الْمساجِد لِلّهِ فلا تدْعُوا مع اللّهِ أحدا (18)}.
{وأنّ الْمساجِد} من جملة الموحى. وقيل معناه: ولأن المساجد لِلّهِ
{فلا تدْعُوا} على أنّ اللام متعلقة بلا تدعوا، أى: فلا تدعوا مع اللّهِ أحدا في المساجد، لأنها للّه خاصة ولعبادته.وعن الحسن: يعنى الأرض كلها، لأنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. وقيل: المراد بها المسجد الحرام، لأنه قبلة المساجد. ومنه قوله تعالى:
{ومنْ أظْلمُ مِمّنْ منع مساجِد اللّهِ أنْ يُذْكر فِيها اسْمُهُ} وعن قتادة: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا باللّه، فأمرنا أن نخلص للّه الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: المساجد أعضاء السجود السبعة. قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
«أمرت أن أسجد على سبعة آراب: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان». وقيل: هي جمع مسجد وهو السجود.
 .[الجن: آية 19]
.[الجن: آية 19]
{وأنّهُ لمّا قام عبْدُ اللّهِ يدْعُوهُ كادُوا يكُونُون عليْهِ لِبدا (19)}.
{عبْدُ اللّهِ} النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: هلا قيل: رسول اللّه أو النبي؟ قلت: لأن تقديره: وأوحي إليّ أنه لما قام عبد اللّه. فلما كان واقعا في كلام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن نفسه: جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل. أو لأن المعنى أن عبادة عبد اللّه للّه ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر، حتى يكونوا عليه لبدا. ومعنى
{قام عبْدُ اللّهِ يدْعُوهُ} قام يعبده، يريد: قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم
{كادُوا يكُونُون عليْهِ لِبدا} أى يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به قائما وراكعا وساجدا، وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله، وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. وقيل معناه: لما قام رسولا يعبد اللّه وحده مخالفا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه: كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين لِبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعض، ومنها (لبدة الأسد) وقرئ:
{لبدا} واللبدة في معنى اللبدة، ولبدا: جمع لابد، كساجد وسجد. ولبدا بضمتين: جمع لبود، كصبور وصبر. وعن قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه. فأبى اللّه إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأه. ومن قرأ:
{وإنه}، بالكسر: جعله من كلام الجن: قالوه لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما رأوا من صلاته وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به.
 .[الجن: الآيات 20- 28]
.[الجن: الآيات 20- 28]
{قُلْ إِنّما أدْعُوا ربِّي ولا أُشْرِكُ بِهِ أحدا (20) قُلْ إِنِّي لا أمْلِكُ لكُمْ ضرّا ولا رشدا (21) قُلْ إِنِّي لنْ يُجِيرنِي مِن اللّهِ أحدٌ ولنْ أجِد مِنْ دُونِهِ مُلْتحدا (22) إِلاّ بلاغا مِن اللّهِ ورِسالاتِهِ ومنْ يعْصِ اللّه ورسُولهُ فإِنّ لهُ نار جهنّم خالِدِين فِيها أبدا (23) حتّى إِذا رأوْا ما يُوعدُون فسيعْلمُون منْ أضْعفُ ناصِرا وأقلُّ عددا (24) قُلْ إِنْ أدْرِي أقرِيبٌ ما تُوعدُون أمْ يجْعلُ لهُ ربِّي أمدا (25) عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحدا (26) إِلاّ منِ ارْتضى مِنْ رسُولٍ فإِنّهُ يسْلُكُ مِنْ بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ رصدا (27) لِيعْلم أنْ قدْ أبْلغُوا رِسالاتِ ربِّهِمْ وأحاط بِما لديْهِمْ وأحْصى كُلّ شيْءٍ عددا (28)}{قُلْ} للمتظاهرين عليه
{إِنّما أدْعُوا ربِّي} يريد: ما أتيتكم بأمر منكر، إنما أعبد ربى وحده
{ولا أُشْرِكُ بِهِ أحدا} وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتى وعداوتي. أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من عبادتي اللّه ورفضى الإشراك به بأمر يتعجب منه، إنما يتعجب ممن يدعو غير اللّه ويجعل له شريكا. أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا رشدا ولا نفعا. أو أراد بالضر: الغىّ، ويدل عليه قراءة أبىّ
{غيا ولا رشدا} والمعنى: لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم، إنما الضارّ والنافع اللّه. أو لا أستطيع أن أقسركم على الغىّ والرشد، إنما القادر على ذلك اللّه عز وجل:
{وإِلّا بلاغا} استثناء منه. أى لا أملك إلا بلاغا من اللّه. و
{قُلْ إِنِّي لنْ يُجِيرنِي} جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفى الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه، على معنى أنّ اللّه إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما: لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه: والملتحد الملتجأ، وأصله المدّخل، من اللحد. وقيل: محيصا ومعدلا. وقرئ:
{قال لا أملك}، فإن قلت: ألا يقال: بلغ عنه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام
«بلغوا عنى بلغوا عنى»؟ قلت: من ليست بصلة للتبليغ، إنما هي بمنزلة من في قوله:
{براءةٌ مِن اللّهِ} بمعنى بلاغا كائنا من اللّه. وقرئ:
{فأن له نار جهنم}، على: فجزاؤه أنّ له نار جهنم، كقوله فأنّ لِلّهِ خُمُسهُ أى: فحكمه أنّ للّه خمسه. وقال خالِدِين حملا على معنى الجمع في من. فإن قلت: بم تعلق
{حتى}، وجعل ما بعده غاية له؟ قلت: بقوله:
{يكُونُون عليْهِ لِبدا} على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة، ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم
{حتّى إِذا رأوْا ما يُوعدُون} من يوم بدر وإظهار اللّه له عليهم. أو من يوم القيامة
{فسيعْلمُون} حينئذ أنهم
{أضْعفُ ناصِرا وأقلُّ عددا} ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال: من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده، كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه
{حتّى إِذا رأوْا ما يُوعدُون} قال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟ إنكارا له، فقيل
{قُلْ} إنه كائن لا ريب فيه، فلا تنكروه، فإن اللّه قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعاد. وأما وقته فما أدرى متى يكون، لأنّ اللّه لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة. فإن قلت: ما معنى قوله:
{أمْ يجْعلُ لهُ ربِّي أمدا} والأمد يكون قريبا وبعيدا ألا ترى إلى قوله:
{تودُّ لوْ أنّ بيْنها وبيْنهُ أمدا بعِيدا}؟ قلت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستقرب الموعد، فكأنه قال: ما أدرى أهو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية أى: هو
{عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ} فلا يطلع. و
{مِنْ رسُولٍ} تبيين لمن ارتضى، يعنى: أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة، لا كل مرتضى. وفي هذا إبطال للكرامات، لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين، فليسوا برسل. وقد خصّ اللّه الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم، لأنّ أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط
{فإِنّهُ يسْلُكُ مِنْ بيْنِ يديْهِ} يدي من ارتضى للرسالة
{ومِنْ خلْفِهِ رصدا} حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم، حتى يبلغ ما أوحى به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبىّ إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك
{لِيعْلم} اللّه
{أنْ قدْ أبْلغُوا رِسالاتِ ربِّهِمْ} يعنى الأنبياء. وحد أولا على اللفظ في قوله:
{مِنْ بيْنِ يديْهِ ومِنْ خلْفِهِ} ثم جمع على المعنى، كقوله:
{فإِنّ لهُ نار جهنّم خالِدِين} والمعنى: ليبلغوا رسالات ربهم كما هي، محروسة من الزيادة والنقصان، وذكر العلم كذكره في قوله تعالى:
{حتّى نعْلم الْمُجاهِدِين} وقرئ:
{ليعلم}، على البناء للمفعول
{وأحاط بِما لديْهِمْ} بما عند الرسل من الحكم والشرائع، لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفا، فهو مهيمن عليها حافظ لها
{وأحْصى كُلّ شيْءٍ عددا} من القطر والرمل وورق الأشجار، وزبد البحار، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه.وعددا: حال، أى: وضبط كل شيء معدودا محصورا. أو مصدر في معنى إحصاء.عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
«من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق محمدا صلى الله عليه وسلم وكذب به عتق رقبة». اهـ.
 .قال الماوردي:
.قال الماوردي:
قوله تعالى:
{قل أوحي إليّ أنّه إسْتمع نفرٌ مِن الجنّ}اختلف أهل التفسير في سبب حضور النفر من الجن إلى رسوله اللّه صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن على قولين:أحدهما: أن الله تعالى صرفهم إليه بقوله:
{وإذا صرفْنا إليك نفرا من الجن} [الأحقاف: 29]، قاله ابن مسعود والضحاك وطائفة.الثاني: أنه كان للجن مقاعد في السماء الدنيا يستمعون منها ما يحدث فيها من أمور الدنيا، فلما بعث اللّه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء الدنيا من الجن ورجموا بالشهب، قال السدي: ولم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو أثر له ظاهر، قال: فلما رأى أهل الطائف اختلاف الشهب في السماء قالوا: هلك أهل السماء فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم، فقال لهم عبد يا ليل بن عمرو: ويحكم أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها لم يهلك أهل السماء، وإنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني محمدا فلما رأوها مستقرة كفّوا.وفزعت الجن والشياطين، ففي رواية السدي أنهم أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم، فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوها فشمها فقال: صاحبكم بمكة فبعث نفرا من الجن..وفي رواية ابن عباس: أنهم رجعوا إلى قومهم فقالوا: ما حال بيننا وبين السماء إلا أمر حدث في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ففعلوا حتى أتوا تهامة، فوجدوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ.ثم اختلفوا لاختلافهم في السبب، هل شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن أم لا؟فمن قال إنهم صرفوا إليه قال إنه رآهم وقرأ عليهم ودعاهم، روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«قد أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ فسكتوا، ثم الثانية فسكتوا، ثم الثالثة، فقال ابن مسعود أنا أذهب معك، فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دُب، فخط عليّ خطا ثم قال: لا تجاوزه، ثم مضى إلى الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل حتى غشوة فلم أره» قال عكرمة: وكانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل.ومن قال إنهم صرفوا في مشارق الأرض ومغاربها لاستعلام ما حدث فيها، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها.روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، وإنما انطلق في نفر من أصحابه إلى سوق عكاظ، فأتوه وهو بنخلة عامدا، إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء.قال عكرمة: السورة التي كان يقرؤها
{اقرأ بِاسْمِ ربِّك} واختلف قائلوا هذا القول في عددهم، فروى عاصم عن زر بن حبيش أنهم كانوا تسعة، أحدهم زوبعة، أتوه في بطن نخلة.وروى ابن جريج عن مجاهد: أنهم كانوا سبعة، ثلاثة من أهل حران، وأربعة من أهل نصيبين، وكانت أسماؤهم: حسى ومسى وماصر وشاصر والأرد وأتيان والأحقم.وحكى جويبر عن الضحاك أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق، وهم سليط وشاصر وماصر وحسا ومنشا ولحقم والأرقم والأرد وأتيان، وهم الذين قالوا:
{إنا سمعنا قرآنا عجبا}، وكانوا قد أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة في صلاة الصبح فصلّوا معه:
{فلما قضى ولّوْا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي اللّه وآمِنوا به}.وقيل إن الجن تعرف الإنس كلها فلذلك توسوس إلى كلامهم.واختلف في أصل الجن، فروى إسماعيل عن الحسن البصري أن الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون وهم شركاء في الثواب والعقاب فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي اللّه، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان.وروى الضحاك عن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجان وليسوا شياطين وهم يموتون، ومنهم المؤمن والكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس.أصلهم، فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم، ومن قال هم من ذرية إبليس فلهم فيها قولان:أحدهما: يدخلونها وهو قول الحسن.الثاني: وهو رواية مجاهد، لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار.وفي قوله تعالى:
{إنا سمِعْنا قرآنا عجبا} ثلاثة أوجه:أحدها: عجبا في فصاحة كلامه.الثاني: عجبا في بلاغة مواعظة.الثالث: عجبا في عظم بركته.
{يهْدِي إلى الرُّشْدِ} فيه وجهان:أحدهما: مراشد الأمور.الثاني: إلى معرفة اللّه.
{وأنّه تعالى جدُّ ربّنا} فيه عشرة تأويلات:أحدها: أمر ربنا، قاله السدي.الثاني: فعل ربنا، قاله ابن عباس.الثالث: ذكر ربنا، وهو قول مجاهد.الرابع: غنى ربنا، قاله عكرمة.الخامس: بلاء ربنا، قاله الحسن.السادس: مُلك ربنا وسلطانه، قاله أبو عبيدة.السابع: جلال ربنا وعظمته، قاله قتادة.الثامن: نعم ربنا على خلقه، رواه الضحاك.التاسع:
{تعالى جد ربنا} أي تعالى ربُّنا، قاله سعيد بن جبير.العاشر: أنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب، ويكون هذا من قول الجن عن جهالة.
{وأنه كان يقول سفيهُنا على اللّهِ شططا} فيه قولان:أحدهما: جاهلنا وهم العصاة منا، قال قتادة: عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس.الثاني: أنه إبليس، قاله مجاهد وقتادة ورواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.ومن قوله:
{شططا} وجهان:أحدهما: جورا، وهو قول أبي مالك.الثاني: كذبا، قاله الكلبي، وأصل الشطط البعد، فعبر به عن الجور لبعده من العدل، وعن الكذب لبعده عن الصدق.
{وأنّه كان رجالٌ من الإنسِ يعُوذون برجالٍ من الجنِّ} قال ابن زيد: إنه كان الرجل في الجاهلية قبل الإسلام إذا نزل بواد قال: إني أعوذ بكبير هذا الوادي- يعني من الجن- من سفهاء قومه، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم، وهو معنى قوله:
{وأنه كان رجال}.وفي قوله:
{فزادُوهم رهقا} ثمانية تأويلات:أحدها: طغيانا، قاله مجاهد.الثاني: إثما، قاله ابن عباس وقتادة، قال الأعشى:
لا شيء ينفعني مِن دُون رؤيتها ** هل يشْتفي عاشقٌ ما لم يُصبْ رهقا.يعني إثما.الثالث: خوفا، قاله أبو العالية والربيع وابن زيد.الرابع: كفرا، قاله سعيد بن جبير.الخامس: أذى، قاله السدي.السادس: غيّا، قاله مقاتل.السابع: عظمة، قاله الكلبي.الثامن: سفها، حكاه ابن عيسى.
{وأنا لمسْنا السّماء} فيه وجهان:أحدهما: طلبنا السماء، والعرب تعبر عن الطلب باللمس تقول جئت ألمس الرزق وألتمس الرزق.الثاني: قاربنا السماء، فإن الملموس مقارب.
{فوجدْناها} أي طرقها.
{مُلئتْ حرسا شديدا} هم الملائكة الغلاظ الشداد.
{وشُهُبا} جمع شهاب وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عند استراق السمع، واختلف في انقضاضها في الجاهلية قبل مبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين:أحدهما: أنها كانت تنقض في الجاهلية، وإنما زادت بمبعث الرسول إنذارا بحاله، قال أوس بن حجر، وهو جاهلي:
فانقضّ كالدُّرِّيِّ يتْبعهُ ** نقعٌ يثورُ تخالُهُ طُنُباوهذا قول الأكثرين.الثاني: أن الانقضاض لم يكن قبل المبعث وإنما أحدثه الله بعده، قال الجاحظ: وكل شعر روي فيه فهو مصنوع.
{وأنّا كُنّا نقْعُدُ منها مقاعِد للسّمْعِ} يعني أن مردة الجن كانوا يقعدون من السماء الدنيا مقاعد للسمع يستمعون من الملائكة أخبار السماء حتى يُلقوها إلى الكهنة فتجري على ألسنتهم، فحرسها اللّه حين بعث رسوله بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذٍ:
{فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا} يعني بالشهاب الكوكب المحرق، والرصد من الملائكة.أما الوحي فلم تكن الجن تقدر على سماعه، لأنهم كانوا مصروفين عنه من قبل.
{وأنّا لا ندْرِي أشرٌ أُريد بمن في الأرضِ أمْ أراد بهم ربُّهم رشدا} فيه وجهان:أحدهما: أنهم لا يدرون هل بعث الله محمدا ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم رشدا ولهم ثوابا، أم يكفروا به فيكون ذلك منهم شرا وعليهم عقابا، وهذا معنى قول السدي وابن جريج.الثاني: أنهم لا يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب، قاله ابن زيد.
{وأنّا مِنّا الصّالحون} يعني المؤمنين.
{ومنّا دون ذلك} يعني المشركين.ويحتمل أن يريد بالصالحين أهل الخير، وب
{دون ذلك} أهل الشر ومن بين الطرفين على تدريج، وهو أشبه في حمله على الإيمان والشرك لأنه إخبار منهم عن تقدم حالهم قبل إيمانهم.
{كُنّا طرائقِ قِددا} فيه ثلاثة تأويلات:أحدها: يعني فِرقا شتى، قاله السدي.الثاني: أديانا مختلفة، قاله الضحاك.الثالث: أهواء متباينة، ومنه قول الراعي:
القابض الباسط الهادي بطاعته ** في فتنة الناس إذ أهواؤهم قِددُ{وأنّا لّما سمِعْنا الهُدى آمنّا به} يعني القرآن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوه على رسالته، وقد كان رسول الله مبعوثا إلى الجن والإنس.قال الحسن: بعث اللّه محمدا إلى الإنس والجن ولم يبعث الله تعالى رسولا من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء، وذلك قوله تعالى:
{وما أرسلْنا مِن قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى}.
{فمن يؤمن بربّه فلا يخافُ بخسا ولا رهقا} قال ابن عباس:لا يخاف نقصا في حسناته، ولا زيادة في سيئاته، لأن البخس النقصان، والرهق: العدوان، وهذا قول حكاه الله عن الجن لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم، وقد روى عمار بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب قال: بينما عمر بن الخطاب جالسا ذات يوم إذ مرّ به رجل، فقيل له: أتعرف المارّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ قالوا: سواد بن قارب رجل من أهل اليمن له شرف، وكان له رئيّ من الجن، فأرسل إليه عمر فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: وأنت الذي أتاك رئيّ من الجن يظهر لك؟ قال: نعم بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رئي من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول:
عجبْتُ للجنّ وتطلابها ** وشدِّها العِيس بأذْنابها.تهوي إلى مكة تبغي الهُدى ** ما صادقُ الجن ككذّابها.فارْحلْ إلى الصفوةِ من هاشمٍ ** فليس قد أتاها كاذبا بهافقلت دعني أنام فإني أمسيت ناعسا، ولم أرفع بما قاله رأسا، فلما كان الليلة الثانية أتاني فضربني برجله، وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى اللّه وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول:
عجبْتُ للجنّ وتخيارها ** وشدِّها العيس بأكوارهاتهوي إلى مكة تبغي الهدي ** ما مؤمن الجن ككفّارِهافارحلْ إلى الصفوةِ من هاشمٍ ** ما بين رابيها وأحجارهافقلت له دعني فإني أمسيت ناعسا، ولم أرفع بما قال رأسا، فلما كان الليلة الثالثة أتاني وضربني برجله، وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول:
عجبت للجن وتحساسها ** وشدِّها العيس بأحْلاسهاتهوي إلى مكة تبغي الهُدي ** ما خيِّرُ الجنّ كأنجاسهافارحلْ إلى الصفوة من هاشم ** واسم بيديْك إلى رأسهاقال: فأصبحت قد امتحن الله قلبي بالإسلام، فرحلتُ ناقتي فأتيت المدينة، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقلت اسمع مقالتي يا رسول اللّه، قال: هات، فأنشأت أقول:
أتاني نجيّ بين هدءٍ ورقْدةٍ ** ولم يك فيما قد تلوْتُ بكاذبِثلاث ليال قوله كل ليلةٍ ** أتاك رسولٌ من لؤيّ بن غالبفشمّرتُ من ذيلي الإزار ووسطت ** بي الذملُ الوجناء بين السباسِبفأشهدُ أن اللّه لا شيء غيرهُ ** وأنك مأمولٌ على كل غالبِوأنك أدني المرسلين وسيلة ** إلى اللّه يا بن الأكرمين الأطايبفمُرنْا بما يأتيك يا خير من مشى ** وإن كان فيما جاء شيبُ الذوائبوكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعةٍ ** سِواك بمغنٍ عن سوادِ بن قاربففرح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرحا شديدا، حتى رئي الفرح في وجوههم، قال: فوثب عمر فالتزمه وقال: قد كنت أشتهي أن أسمع منك هذا الحديث، فهل يأتيك رئيك من الجن اليوم؟ قال: أما وقد قرأت القرآن فلا، ونعم العوض كتاب اللّه عن الجن.
{وأنّا مِنّا المسْلِمون ومِنّا القاسِطون} وهذا إخبار عن قول الجن بحال من فيهم من مؤمن وكافر، والقاسط: الجائر، لأنه عادل عن الحق، ونظيره الترِب والمُتْرِب، فالترِب الفقير، لأن ذهاب ماله أقعده على التراب، والمترب الغني لأن كثرة ماله قد صار كالتراب.وفي المراد بالقاسطين ثلاثة أوجه:أحدها: الخاسرون، قاله قتادة.الثاني: الفاجرون، قاله ابن زيد.الثالث: الناكثون، قاله الضحاك.
{وأن لو استقاموا على الطريقة} ذكر ابن بحر أن كل ما في هذه السورة من (أن) المكسورة المثقلة فهو حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين، وكل ما فيها من (أن) المفتوحة المخففة أو المثقلة فهو من وحي الرسول.وفي هذه الاستقامة قولان:أحدهما: أنها الإقامة على طريق الكفر والضلالة، قاله محمد بن كعب وأبو مجلز وغيرهما.الثاني: الاستقامة على الهدى والطاعة، قاله ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد فمن ذهب إلى أن المراد الإقامة على الكفر والضلال فلهم في قوله:
{لأسْقيْناهم ماء غدقا} وجهان:أحدهما: بلوناهم بكثرة الماء الغدق حتى يهلكوا كما هلك قوم نوح بالغرق، وهذا قول محمد بن كعب.الثاني: لأسقيناهم ماء غدق ينبت به زرعهم ويكثر مالهم.
{لِنفْتِنهم فيه} فيكون زيادة في البلوى، حكى السدي عن عمر في قوله:
{لأسقيناهم ماء غدقا} أنه قال: حيثما كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة، فاحتملت الفتنة هاهنا وجهين:أحدهما: افتننان أنفسهم.الثاني: وقوع الفتنة والشر من أجله.وأما من ذهب إلى أن المراد الاستقامة على الهدى والطاعة فلهم في تأويل قوله:
{لأسقيناهم ماء غدقا} أربعة أوجه:أحدها: معناه لهديناهم الصراط المستقيم، قاله ابن عباس.الثاني: لأوسعنا عليهم في الدنيا، قاله قتادة.الثالث: لأعطيناهم عيشا رغدا، قاله أبو العالية.الرابع: أنه المال الواسع، لما فيه من النعم عليهم بحياة النفوس وخصب الزروع، قاله أبو مالك والضحاك وابن زيد.وفي الغدق وجهان:أحدهما: أنه العذب المعين، قاله ابن عباس، قاله أمية بن أبي الصلت:
مِزاجُها سلسبيلٌ ماؤها غدقٌ ** عذْبُ المذاقةِ لا مِلْحٌ ولا كدرٌالثاني: أنه الواسع الكثير، قاله مجاهد، ومنه قول كثير:
وهبتُ لسُعْدى ماءه ونباته ** فما كل ذي وُدٍّ لمن ودّ واهبُ.لتروى به سُعدى ويروى محلّها ** وتغْدق أعداد به ومشاربفعلى هذا فيه وجهان:أحدهما: أنه إخبار عن حالهم في الدنيا.الثاني: أنه إخبار عن حالهم في الآخرة لنفتنهم فيه.فإن قيل إن هذا وارد في أهل الكفر والضلال كان في تأويله ثلاثة أوجه:أحدها: افتتان أنفسهم بزينة الدنيا.الثاني: وقوع الفتنة والاختلاف بينهم بكثرة المال.الثالث: وقوع العذاب بهم كما قال تعالى:
{يوم هم على النار يُفْتنون} [الذاريات: 13] أي يعذبون.وإن قيل إنه وارد في أهل الهدى والطاعة فهو على ما قدمنا من الوجهين.وهل هو اختبارهم في الدنيا ففي تأويله ثلاثة أوجه:أحدها: لنختبرهم به، قاله ابن زيد.الثاني: لنطهرهم من دنس الكفر.الثالث: لنخرجهم به من الشدة والجدب إلى السعة والخصب.فإن قيل إنه إخبار عمّا لهم في الآخرة ففي تأويله وجهان:أحدهما: لنخلصهم وننجيهم، مأخوذ من فتن الذهب إذا خلّصه مِن غشه بالنار كما قال تعالى لموسى عليه السلام:
{وفتنّاك فُتونا} [طه: 40] أي خلصناك من فرعون. الثاني: معناه لنصرفنهم عن النار، كما قال تعالى:
{وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوْحينْا إليك لتفْتري علينا غيره} [الإسراء: 73] أي ليصرفونك
{ومنْ يُعْرِضْ عن ذِكْرِ ربِّه} قال ابن زيد: يعني القرآن وفي إعراضه عنه وجهان:أحدهما: عن القبول، إن قيل إنها من أهل الكفر.الثاني: عن العمل، إن قيل إنها من المؤمنين.
{يسْلُكْهُ عذابا صعدا} فيه ثلاثة أوجه:أحدها: أنه جب في النار، قاله أبو سعيد.الثاني: جبل في النار إذا وضع يده عليه ذابت، وإذا رفعها عادت، وهو مأثور، وهذان الوجهان من عذاب أهل الضلال.والوجه الثالث: أنه مشقة من العذاب يتصعد، قاله مجاهد.
{وأنّ المساجد للّهِ} فيه أربعة أقاويل:أحدها: يعني الصلوات للّه، قاله ابن شجرة.الثاني: أنها الأعضاء التي يسجد عليها للّه، قاله الربيع.الثالث: أنها المساجد التي هي بيوت اللّه للصلوات، قاله ابن عباس.الرابع: أنه كل موضع صلى فيه الإنسان، فإنه لأجل السجود فيه يسمى مسجدا.
{فلا تدْعُوا مع اللّهِ أحدا} أي فلا تعبدوا معه غيره، وفي سببه ثلاثة أقاويل:أحدها: ما حكاه الأعمش أن الجن قالت: يا رسول الله ائذن لنا نشهد معك الصلاة في مسجدك، فنزلت هذه الآية.الثاني: ما حكاه أبو جعفر محمد بن علّي أن الحمس من مشركي أهل مكة وهم كنانة وعامر وقريش كانوا يُلبّون حول البيت: لبيّك اللهم لبيّك، لبيّك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فأنزل اللّه هذه الآية نهيا أن يجعل للّه شريكا، وروى الضحاك عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدّم رجله اليمنى وقال:
{وأن المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا} «اللهم أنا عبدك وزائرك، وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار» وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال:
«اللهم صُبّ الخير صبّا ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا ولا تجعل معيشتي كدّا واجعل لي في الخير جدا».
{وأنه لما قام عبدُ اللّهِ يدعوه} يعني محمدا، وفيه وجهان:أحدهما: أنه قام إلى الصلاة يدعو ربه فيها، وقام أصحابه خلفه مؤتمين، فعجبت الجن من طواعية أصحابه له، قاله ابن عباس.الثاني: أنه قام إلى اليهود داعيا لهم إلى اللّه، رواه ابن جريج.
{كادوا يكونون عليه لِبدا} فيه وجهان:أحدهما: يعني أعوانا، قاله ابن عباس.الثاني: جماعات بعضها فوق بعض، وهو معنى قول مجاهد، ومنه اللبد لاجتماع الصوف بعضه على بعض، وقال ذو الرمة:
ومنهلٍ آجنٍ قفرٍ مواردهُ ** خُضْرٍ كواكبُه مِن عرْمصٍ لبِدِوفي كونهم عليه لبدا ثلاثة أوجه:أحدها: أنهم المسلمون في اجتماعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن جبير. الثاني: أنهم الجن حين استمعوا من رسول اللّه قراءته، قاله الزبير بن العوام. الثالث: أنهم الجن والإنس في تعاونهم على رسول اللّه في الشرك، قاله قتادة.
{قلْ إني لا أمْلِكُ لكم ضرّا ولا رشدا} يعني ضرا لمن آمن ولا رشدا لمن كفر، وفيه ثلاثة أوجه:أحدها: عذابا ولا نعيما.الثاني: موتا ولا حياة.الثالث: ضلالا ولا هدى.
{قل إني لن يُجيرني مِن اللّهِ أحدٌ} روى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال: انطلقتُ مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط خطا ثم تقدم عليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أزجلهم عنك، فقال:
{إني لن يجيرني من اللّه أحد}ويحتمل وجهين:أحدهما: لن يجيرني مع إجارة اللّه لي أحد.الثاني: لن يجيرني مما قدره الله علي أحد.
{ولن أجد مِن دُونهِ ملْتحدا} فيه ثلاثة أوجه:أحدها: يعني ملجأ ولا حرزا، قاله قتادة.الثاني: وليا ولا مولى، رواه أبو سعيد.الثالث: مذهبا ولا مسلكا، حكاه ابن شجرة، ومنه قول الشاعر:
يا لهف نفْسي ولهفي غيرُ مُجْديةٍ ** عني وما مِن قضاءِ اللّهِ مُلْتحدُ.{إلا بلاغا مِن اللّه ورسالاتِه} فيه وجهان:أحدهما: لا أملك ضرا ولا رشدا إلا أن أبلغكم رسالات اللّه، قاله الكلبي.الثاني: لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالات اللّه، قاله مقاتل.روى مكحول عن ابن مسعود: أن الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وكانوا سبعين ألفا، وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر.
{عالِمُ الغيْب} فيه أربعة أوجه:أحدها: عالم السر، قاله ابن عباس.الثاني: ما لم تروه مما غاب عنكم، قاله الحسن.الثالث: أن الغيب القرآن، قاله ابن زيد.الرابع: أن الغيب القيامة وما يكون فيها، حكاه ابن أبي حاتم.
{فلا يُظْهِرُ على غيْبه أحدا إلا من ارتضى من رسول} فيه ثلاثة أوجه:أحدها: إلا من ارتضى من رسول الله هو جبريل، قاله ابن جبير.الثاني: إلا من ارتضى من نبي فيما يطلعه عليه من غيب، قاله قتادة.
{فإنه يسْلُكُ مِن بيْن يديْه ومِنْ خلْفه رصدا} فيه قولان:أحدهما: الطريق، ويكون معناه فإنه يجعل له إلى علم بعض ما كان قبله وما يكون بعده طريقا، قاله ابن بحر.الثاني: أن الرصد الملائكة، وفيهم ثلاثة أقاويل:أحدها: أنهم حفظة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والشياطين من أمامه وورائه، قاله ابن عباس وابن زيد، قال قتادة: هم أربعة.الثاني: أنهم يحفظون الوحي فما جاء من الله قالوا إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان، قاله السدي.الثالث: يحفظون جبريل إذا نزل بالوحي من السماء أن يسمعه الجن إذا استرقوا السمع ليلقوه إلى كهنتهم قبل أن يبلغه الرسول إلى أمته، قاله الفراء.
{ليعْلم أنْ قد أبْلغوا رسالاتِ ربِّهم} فيه خمسة أوجه:أحدها: ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل إليه رسالات ربه، قاله ابن جبير، وقال: ما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة من الملائكة.الثاني: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد بلغت رسالات الله وحفظت، قاله قتادة.الثالث: ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغت عن ربها ما أمرت به، قاله مجاهد.الرابع: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم، ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم، قاله ابن قتيبة.الخامس: ليعلم الله أن رسله قد بلغوا عنه رسالاته، لأنبيائه، قاله الزجاج.
{وأحاط بما لديهم} قال ابن جريج: أحاط علما.
{وأحْصى كُلّ شيءٍ عددا} يعني من خلقه الذي يعزب إحصاؤه عن غيره. اهـ.